تعريف الإيمان: رحلةٌ إلى جذور اليقين وأعماق الروح
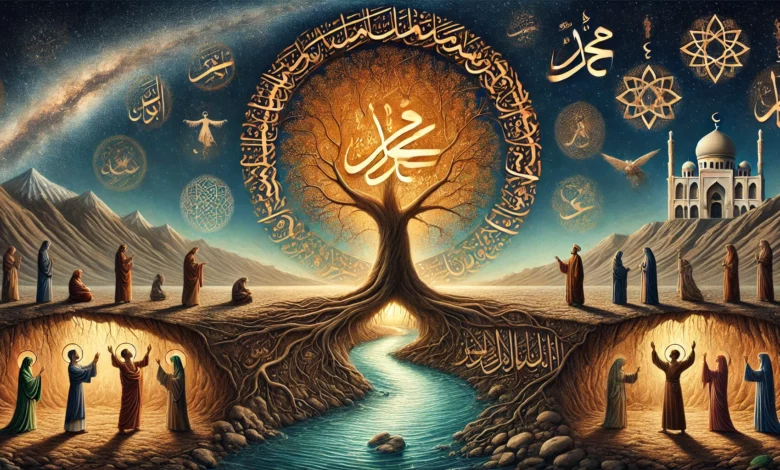
في صمتِ الليلِ، حينَ تهمسُ النجومُ بأسرارِ الكون، وتتوقُ الروحُ إلى مرفأٍ تأوي إليه، يطلُّ الإيمان كضوءٍ لا ينطفئ. إنه ذلك الحبلُ السريُّ الذي يربطُ الإنسانَ بجوهرِ وجوده، ويمنحُ الحياةَ نكهةَ الخلود. لكن، ما هو الإيمان؟ هل هو مجردُ كلمةٍ تتردَّدُ على الألسنة، أم هو نهرٌ جارٍ في أعماقِ الوجدان؟ دعونا نغوصُ معًا في أعماقِ هذه الكلمة، نقتفي جذورَها اللغويةَ، ونستنطقُ فلسفتَها، ونستلهمُ دلالاتِها التي صاغت حضاراتٍ بأكملها.
الأصل اللغوي: كلمةٌ نبتت من قلبِ الأمان
لو عُدنا بالزمنِ إلى الوراء، إلى تلك الأيامِ التي كانتِ اللغةُ العربيةُ تُنسجُ خيوطَها الأولى، لوجدنا أنَّ كلمةَ “الإيمان” قد انبثقتْ من الفعلِ “أمِنَ”، الذي يحملُ في طياتِه معنى الأمانِ والتصديقِ والاطمئنان. كأنَّ الإنسانَ، حينَ يؤمن، يجدُ ملاذًا من رعبِ الشكِّ، ويُطفئُ ظمأَ قلبهِ إلى اليقين.
ولعلَّ هذه الجذورَ اللغويةَ تتشابه مع أخواتِها في اللغاتِ السامية، ففي العبريةِ تُلفظُ “אמונה” (أمونة)، وفي الآراميةِ “ܗܝܡܢܘܬܐ” (هايمانوتا)، وكأنَّ الشعوبَ القديمةَ اتفقتْ على أنَّ الإيمانَ هو ذلك الجسرُ الذي يعبرُ بهِ الإنسانُ من ضفةِ الخوفِ إلى ضفةِ الطمأنينة.
أما في العصرِ الجاهليِّ، فقد رافقَ الإيمانُ الإنسانَ كشريكٍ في رحلةِ البحثِ عن المعنى، فها هو الشاعرُ طرفةُ بنُ العبدِ يُصوِّرُه في بيتِه الخالد:
وَإِنِّي لَتَطْرَبُنِي الخَيْلُ وَالأَثَرُ … كَطَرَبِ أَوَالِيّ بِالإيمَانِ تَزْدَهَرُ
حيثُ يربطُ بين بهجةِ الخيلِ وازدهارِ الإيمانِ، وكأنَّ الإيمانَ زهرةٌ تتفتحُ في تربةِ الروحِ عندما تُروى بالصدقِ والشغفِ.
بين اللغةِ والشرعِ: هل الإيمانُ تصديقٌ أم عملٌ؟
في معجمِ اللغةِ، يظلُّ الإيمانُ شقيقًا للتصديقِ، لكنَّ الشرعَ أضافَ إليهِ أجنحةً لِيَحلِّقَ بعيدًا. ففي لسانِ العربِ، “آمنَ بهِ” تعني صدَّقهُ واطمأنَّ إليهِ، لكنَّ الإسلامَ جاءَ لِيَحوِّلَ هذا التصديقَ إلى شجرةٍ تُثمرُ أعمالًا.
ففي الحديثِ النبويِّ الشريفِ:
“الإيمانُ أنْ تؤمنَ باللهِ وملائكتِه وكتبِه ورسلِه واليومِ الآخرِ، وتؤمنَ بالقدرِ خيرِه وشرِّه”.
هنا، يصيرُ مفهومُ الإيمانِ جسدًا وروحًا: فالتصديقُ بالقلبِ هو الروحُ، والأعمالُ بالجوارحِ هي الجسدُ. لكنَّ السؤالَ يظلُّ يترددُ: أيُّهما أولى؟
لقد اختلفتِ المدارسُ الإسلاميةُ في ذلك؛ فبينما رأى أهلُ السنةِ أنَّ الإيمانَ “قولٌ وعملٌ يزيدُ وينقصُ”، اعتبرتِ المرجئةُ أنَّه تصديقٌ بالقلبِ فقط، وكأنَّهم فصلوا بين الشجرةِ وثمرتِها.
الإيمانُ في ميزانِ الروحِ والمجتمعِ
إذا كانَ الإيمانُ في اللغةِ طمأنينةً، وفي الشرعِ التزامًا، فإنَّه في القلبِ البشريِّ ثورةٌ! ثورةٌ تُحرِّرُ الإنسانَ من عبوديةِ المادَّةِ، وتصوغُ منه كائنًا أخلاقيًّا. يقولُ اللهُ تعالى:
﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الرعد: 28].
هذه الآيةُ تُجسِّدُ معنى الإيمانِ الحقيقي: سلامٌ داخليٌّ لا يُشترى بكنوزِ الأرضِ. أما في المجتمعِ، فالإيمانُ ليس مجردَ شعائرَ فرديةٍ، بل هو نسيجٌ خفيٌّ يربطُ القلوبَ، كما في الحديثِ:
“مَثَلُ المؤمنينَ في توادِّهم وتراحمِهم كمثلِ الجسدِ الواحدِ، إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى لهُ سائرُ الجسدِ بالسهرِ والحمى”.
فالإيمانُ هنا يصيرُ حضارةً تُبنى على العدلِ والرحمةِ، لا على مجردِ طقوسٍ جوفاءَ.
الإيمانُ عبرَ عدسةِ الفلاسفةِ والعلمِ
حينَ نقفُ على أطلالِ فلسفةِ “كانط”، نجدُهُ يرفعُ شعارَ: “الإيمانُ العمليُّ” كأساسٍ للأخلاقِ، فالإيمانُ عندهُ ليس مجردَ عقيدةٍ، بل هو قرارٌ أخلاقيٌّ يمنحُ الحياةَ معنى. أما العلمُ الحديثُ، فها هو يكتشفُ ما سبقَ إليهِ القرآنُ: فدراساتُ جامعةِ هارفاردَ (2019) تؤكِّدُ أنَّ الأشخاصَ المؤمنينَ أقلُّ عرضةً للاكتئابِ، وأكثرُ قدرةً على مواجهةِ الأزماتِ، وكأنَّ الإيمانَ درعٌ واقٍ للروحِ.
أسئلةٌ تبحثُ عن إجاباتٍ
- هل الإيمانُ ثابتٌ أم متغيرٌ؟
الإيمانُ كالنهرِ: جوهَرُهُ واحدٌ (التصديقُ بالغيبِ)، لكنَّ مسارَهُ يختلفُ باختلافِ الثقافاتِ والأزمنةِ. - ما الفرقُ بين الإيمانِ والتقوى؟
الإيمانُ هو الجذرُ، والتقوى هي الثمرةُ: فالتقوى خشيةٌ تدعو إلى العملِ، بينما الإيمانُ يقينٌ يملأُ القلبَ.
الخاتمة: الإيمانُ.. ذلك الغريبُ الذي نعرفُه!
في نهايةِ الرحلةِ، نعودُ إلى نقطةِ البدايةِ، لكنَّنا نعودُ بقلوبٍ أثقلُ وعيًا. الإيمانُ ليس كلمةً تُكتبُ، بل هو نداءٌ يهزُّ الأعماقَ، ويُحيي المواتَ فينا. إنه ذاكَ السرُّ الذي جعلَ الحكماءَ يقولون: “من فقدَ إيمانَه، فقدَ نفسَه”. فهل نُصغي إلى صداهُ؟!
مراجعُ المقالِ:
- القرآن الكريم.
- صحيح مسلم.
- لسان العرب لابن منظور.
- دراسة: “الدين والصحة النفسية” – جامعة هارفارد (2019).
- كتاب “نقد العقل العملي” لإيمانويل كانط.







