معنى العلمانية: أصل الكلمة، دلالاتها، وتطورها التاريخي
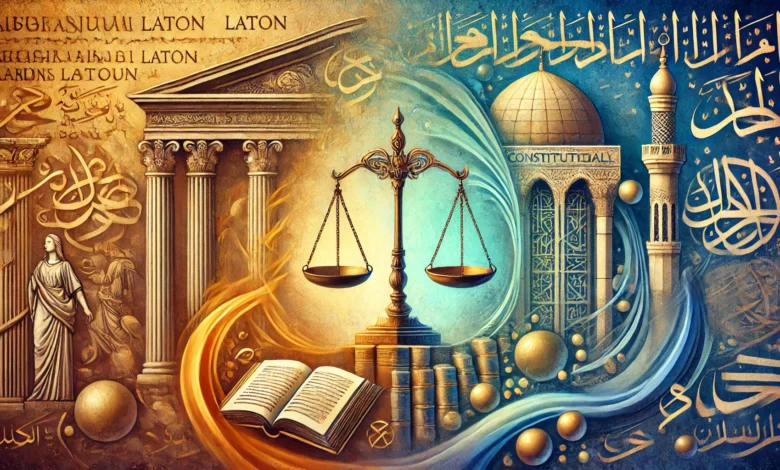
أتَعْلمُ، أيها القارئ الكريم، أنَّ كلمةً واحدةً قد تُثير عواصفَ من الجدل، تُحرِّك سُكون اليقين، وتُقلقُ مياهَ الأفكار الراكدة؟ تلك هي “العلمانية”.. كلمةٌ تتنازعها الألسن بين مُبَجِّلٍ ورافض، بين مَن يراها خلاصًا من وطأة التطرف، وآخرَ يَصِمُها بالإلحاد. لكن، هل العلمانيةُ حقًّا عدوةُ الدين؟ أم هي جسرٌ بين سماواتِ المعتقد وأرضِ الواقع؟ في هذا المقال، سنسبر أغوارَ الكلمة التي هزَّت عروشَ الملوك والكهنة، ونعبرُ بها من شواطئ اللاتينية القديمة إلى ميادين الثورات الحديثة، مُسلِّطين الضوءَ على جذورها، تياراتِها، وأسئلتِها التي ما تزال تُرافقُنا في شرقِنا العربي كظلٍّ طويل.
الفصل الأول: أصل الكلمة.. حين كانت “العلمانية” تعني “الدنيا”
في البدء كانت الكلمة.. وفي اللاتينية وُلدت. انطلقْ معي إلى القرن السابع عشر، حيث كانت أوروبا تئنُّ تحت صراعٍ دامٍ بين سلطتين: كرسي البابا المُقدس، وعرشُ الملك الذي يريدُ أن يحكمَ دون وصاية. هنا، انبثق مصطلح “Secularis” من رحم الفلسفة، ليعني “ما هو دنيوي”، مقابل “Sacred” المُتعلِّق بالدين. لم تكن الكلمةُ عدوانيةً ولا ثوريةً، بل مجردَ تمييزٍ بين مملكةِ القيصر ومملكةِ الله.
لكن، ككلِّ الكلمات العظيمة، لم تبقَ “العلمانية” ساكنةً. حملها الفلاسفةُ كـ”جون لوك” في إنجلترا، الذي نادى بأنَّ الإيمانَ شأنٌ خاص، بينما القانونُ يجب أن يُبنى على العقلِ والمصلحة العامة. ثم انتقلت الكلمةُ إلى العربية كـ”اللا دينية”، لكنَّ الترجمةَ خانَتها، كما يذكرُ المفكِّر “عزيز العظمة” في كتابه “العلمانية في الفكر العربي الحديث”، فصار البعضُ يراها مرادفًا للإلحاد، بينما جوهرُها الحقيقي هو إدارةُ التنوع، لا إنكارُ المقدس.
الفصل الثاني: التعريف.. عندما تلبس العلمانيةُ أثوابًا متعددة
العلمانيةُ كالفلسفة: تتسعُ لتناقضاتِ البشر. يقول “قاموس أكسفورد” إنها فصلُ الدين عن الدولة، لكنَّ الفيلسوفَ “شارل تايلور” يرى أنها ليست مجردَ فصل، بل ضمانُ حيادِ الفضاء العام، حيث لا يُجبرُ أحدٌ على اعتناقِ دين، ولا يُمنعُ من ممارسته. هنا ينقسمُ المفهومُ إلى تيارين:
- العلمانية السياسية: كما في فرنسا الثائرة، التي أعلنت عام 1905 قانونَ الفصلِ بين الكنيسة والدولة، فمنعتِ الحجابَ في المدارس، كي تظلَّ الهويةُ الوطنيةُ فوق كلِّ رمزٍ ديني.
- العلمانية التعددية: كما في الهند، حيث تُعلن الدولةُ حيادَها الديني، لكنها تسمحُ للمواطنُ أن يصلِّي في المعبدِ أو المسجدِ، ثم ينتخبُ مرشحًا علمانيًا.
أما العلمانيةُ الفلسفية، فهي رؤيةٌ وجوديةٌ ترفضُ أيَّ مرجعيةٍ غيبية، لكنَّ هذا التيارَ ليس جوهرَ العلمانية، بل أحدُ فروعِها الذي التصقَ بها في سجالاتِ الخصوم.
الفصل الثالث: الدلالات والصراع.. بين حريةِ الفرد ووحشةِ الهُوية
ماذا يقولُ المؤيدون؟ إنها حصانةٌ ضدَّ الاستبدادِ المقدس. أتَذكرُ كيفَ استخدمَ الملكُ لويس الرابع عشر الدينَ لتبريرِ حكمه المطلق؟ العلمانيةُ هنا تُذكِّرنا أنَّ العدلَ الأرضيَّ لا يحتاج إلى تفويضٍ سماوي. وهي أيضًا، كما كتبَ “عبد الله النعيم” في “الإسلام والعلمانية”، تضمنُ للمسلمِ أن يُطبِّقَ شريعتَه في بيته، دون أن يُلزمَ بها جارَه المسيحي.
لكنْ، ثمةَ ظلٌّ آخرُ للعلمانية. في تركيا، مثلاً، حوَّل أتاتورك العلمانيةَ إلى مطرقةٍ لكسرِ الهوية الإسلامية، بمنع الأذانِ العربي وفرضِ القبعةِ الغربية. هنا يثورُ النقادُ: أليست العلمانيةُ وجهًا آخرَ للاستعمارِ الثقافي؟ ويُجيبُ المؤيدون: الخطأُ ليس في الفكرة، بل في التطبيق. فالعلمانيةُ الصحيةُ كالشمسِ، يجبُ ألا تحرقَ، بل تُنير.
الفصل الرابع: العلمانيةُ العربية.. من أحلام التنوير إلى كوابيس الاستقطاب
في الشرق، تحملُ العلمانيةُ جراحَ التاريخ. بدأت مع “رفاعة الطهطاوي” الذي أعجبَ بفصلِ الدين عن الدولة في فرنسا، ثم “فرح أنطون” الذي دعا في مطلعِ القرن العشرين إلى دولةٍ مدنيةٍ تستلهمُ المنطقَ لا النصَّ. لكنَّ رياحَ الغربِ جاءت مع الاستعمار، فصارَت العلمانيةُ في وعيِ الكثيرين مرادفًا للتبعية.
اليوم، تونسُ تُقدِّم نموذجًا مختلفًا: دستورُ 2014 يفصلُ الدينَ عن السياسة، لكنه يُلزمُ الدولةَ بحمايةِ الحرياتِ الدينية. بينما في مصر، اشتعلَ الجدلُ عام 2012 حولَ مادةٍ دستوريةٍ تسمحُ بمرجعيةِ الشريعة، وكأنَّ السؤالَ القديمَ يعود: هل يمكنُ أن تكونَ علمانيًا دون أن تتنكَّرَ لترابِ تراثك؟
الفصل الخامس: تصحيحُ الأوهام.. ما لا تعرفه عن العلمانية
- الوهم الأول: “العلمانية ضد الدين”. الحقيقة: دستورُ الهند العلماني يُنصِّبُ هندوسيًا رئيسًا ومسلمًا نائبًا.
- الوهم الثاني: “العلمانية غربيةٌ فقط”. الحقيقة: اليابانُ البوذيةُ تطبقُها منذ القرن الـ19.
- الوهم الثالث: “العلمانية فوضى أخلاقية”. الحقيقة: النرويجُ العلمانيةُ تحتلُ المرتبةَ الأولى عالميًا في العدالةِ الاجتماعية، وفقَ تقاريرِ الأمم المتحدة.
الخاتمة: هل نصلحُ العلمانيةَ أم تُصلحنا؟
في النهاية، ليست العلمانيةُ دينًا جديدًا، ولا هي نهايةُ التاريخ. إنها ببساطةٍ.. طريقةٌ لإدارةِ الاختلاف. قد نرفضُها أو نقبلُها، لكنَّ الحوارَ حولها يحتاجُ إلى شجاعةٍ نادرة: شجاعةِ الاعترافِ بأنَّ البشرَ ليسوا ملائكةً ولا شياطين، بل كائناتٌ تبحثُ عن عدالةٍ في دنيا مليئةٍ بالأسئلة. فهل نستطيعُ، في شرقنا الحائر، أن نبتكرَ علمانيةً تنبتُ من ترابِنا، لا أن نستوردَها جاهزةً كسلعةٍ غربية؟ الإجابةُ، أيها القارئ، تبدأُ عندما نجرؤُ على طرحِ السؤال.
مراجعُ المقال :
- جذور العلمانية والتغريب في العالم الإسلامي.
- الجدل حول العلمانية في السياق الإسلامي.
- نظرية العلمانية عند عزمي بشارة.







