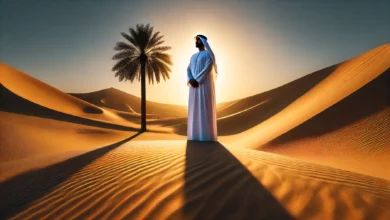تعريف العقل الجمعي: سِرُّ القوة التي تُشكِّلُ مصيرَ الأمم!
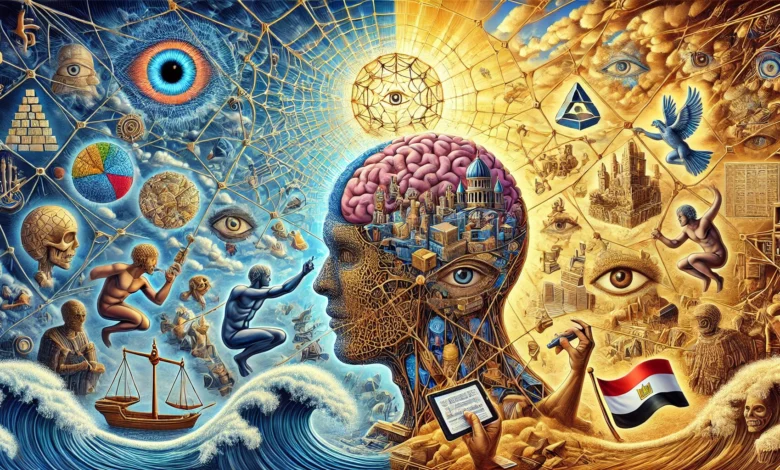
أتَعرفُ ذلك الشعورَ الغامضَ حين تَجدُ نفسَكَ فجأةً تُصفِّقُ مع آلافِ الناس في حفلٍ موسيقي دون أن تُدركَ السبب؟ أو حين تَشتري سلعةً لم تَكُن في حاجةٍ إليها، لمجرد أن “الجميعَ يفعلون ذلك”؟ لعلَّ هذه الظواهرَ ليستْ محضَ صدفةٍ، بل هي شاهدٌ حيٌّ على قوةٍ خفيةٍ تتحكمُ فينا أحيانًا… قوةُ “العقل الجمعي”!
فما هذا الكائنُ الغامضُ الذي يَختبئُ خلفَ سلوكياتنا الجماعية؟ هل هو عقلٌ واحدٌ يجمعُنا أم هو وهمٌ نصنعُه لنبررَ جنونَ الجماهير؟ دعنا نُبحرُ معًا في ثنايا هذا المفهوم الذي شغلَ الفلاسفةَ وعلماءَ الاجتماع، وحوَّلَ مجتمعاتٍ بأكملها من ظلامِ التشتتِ إلى نورِ الوحدةِ… أو العكس!
الأصل اللغوي والتاريخي:
الجذورُ الفلسفيةُ: مِن “سقراط” إلى “ابن خلدون”
لَطالما شَغلتْ فكرةُ “العقل الجمعي” أذهانَ الحكماءِ منذُ فجرِ التاريخ. ففي أثينا القديمة، حذَّرَ سقراطَ من “طغيانِ الأغلبية”، بينما رأى أفلاطونَ في “الجمهورِ” كائنًا مُتقلبًا كالبحرِ الهائج. لكنَّ المفهومَ بدأَ يتشكلُ علميًا في القرن التاسع عشر، حين أطلقَ الفرنسيُّ “غوستاف لوبون” صرختَه الشهيرة في كتابه “سيكولوجية الجماهير”: “الجماهيرُ كالوحوشِ، تَحمِلُ قوةً تدميريةً حين تفقدُ عقلَها الفردي!”.
وفي العالمِ الإسلاميِّ، لم يَكُنِ الفكرُ بعيدًا عن هذا الجدل. فابنُ خلدون، في مقدمتِه الخالدة، تحدثَ عن “العصبيةِ” كعقلٍ جمعيٍّ يَربطُ القبيلةَ ويُحركها نحو الغزوِ أو السلم. وكأنَّما أرادَ أن يقولَ لنا: “الأفرادُ يموتون، لكنَّ العقلَ الجمعيَّ خالدٌ!”.
القرنُ العشرون: حين أصبحَ “اللاوعي الجمعيُّ” أسطورةً عصريةً!
معَ صعودِ علمِ النفسِ، أعادَ “كارل يونغ” صياغةَ الفكرةِ عبرَ مصطلحِ “اللاوعي الجمعي”، زاعمًا أننا نَحملُ في أعماقنا ذاكرةً مشتركةً من الرموزِ والأساطير. لكنَّ المفارقةَ أنَّ العلمَ الحديثَ، بآلاتِه الرقميةِ، قدَّمَ لنا تفسيرًا أكثرَ إثارةً: ففي عصرِ “التيك توك” و”تويتر”، صرنا نرى العقلَ الجمعيَّ وهو يَنسجُ أفكارَنا كخيوطَ عنكبوتٍ غيرِ مرئيةٍ!
المعنى والدلالات:
ما هو “مفهوم العقل الجمعي”؟ بين الحكمةِ والجنونِ!
لنُبسطِ الأمرَ: العقلُ الجمعيُّ هو تلكَ “الشخصيةُ الجديدة” التي تولدُ حين يذوبُ الأفرادُ في جماعةٍ، فيفقدونَ نقديتَهم ويَتبنونَ أفكارًا وسلوكياتٍ مُوحدةً. إنه كالنيازكِ: قد يُضيءُ سماءَ الإبداعِ (كما في حركاتِ الفنِّ الثورية)، أو يُحرقُ كلَّ شيءٍ في طريقِه (كما في الحروبِ الأهلية).
ولكنْ! احذرْ أن تخلطَ بينه وبينَ “عقليةِ القطيع“، فالأخيرةُ ساذجةٌ كالأغنامِ، بينما العقلُ الجمعيُّ قد يكونُ عبقريًا… أو مجرمًا!
شواهدُ تاريخيةٌ: مِن “الربيع العربي” إلى “انهيارِ البورصات”
تَذكَّروا يومَ انهيارِ سوقِ الأسهمِ عامَ 2008: لم يكنْ قرارًا اقتصاديًّا، بل كانَ هستيريا جماعيةً! وكما قالَ “إميل دوركهايم“: “المجتمعُ ليسَ مجموعَ أفراده، بل كائنٌ له روحٌ مستقلةٌ”.
وفي ساحاتِ “الربيع العربي“، رأينا كيفَ يتحولُ اليأسُ الفرديُّ إلى إعصارٍ جمعيٍّ يُزيلُ أنظمةً كالرمالِ أمامَ المدِّ. لكنَّ السؤالَ يبقى: مَن يقودُ هذا العقلَ؟ هل هو الشعبُ… أم مَن يَختفي خلفَ الستارة؟
الآثارُ الاجتماعيةُ: بينَ البناءِ والهدمِ!
الإيجابياتُ: حين يصنعُ “الجميعُ” مُعجزةً!
ماذا لو أخبرتُكَ أنَّ “ويكيبيديا”، أكبرَ موسوعةٍ في التاريخ، هي نتاجُ عقلٍ جمعيٍّ؟ نعم! فـ”التعاونُ” هو أعظمُ وجوهِ العقلِ الجمعيِّ. وحتى في تراثنا، لم تَكُنْ “حلقةُ العلماءِ” في المساجدِ إلا شكلًا راقيًا من حكمةِ الجماعةِ.
السلبياتُ: حين تَصيرُ الجماعةُ “غولًا”!
لكنَّ الجانبَ المظلمَ لهذا المفهومِ يُذكرنا بكارثةِ “النازية”، حيثُ تحولَ الشعبُ الألمانيُّ إلى آلةٍ طائشةٍ. وكما كتبَ “إريك فروم“: “الهروبُ من الحريةِ” قد يَجعلُ الجماهيرَ تَستبدلُ العقلَ بالتبعيةِ العمياءِ!
العصرُ الرقميُّ: هل صِرنا جميعًا “خلايا” في مخٍ إلكترونيٍّ؟
أليسَ غريبًا أن تَضحكَ ملايينُ الأشخاصَ على “ميمٍ” واحدٍ دون أن يَتفقوا على سببِ الضحك؟ إنها مفارقةُ العصرِ: فالشبكاتُ الاجتماعيةُ حوَّلتِ العقلَ الجمعيَّ إلى لعبةٍ إلكترونيةٍ، نَختارُ فيها أن نكونَ “تابعينَ” بضغطةِ زرٍّ!
بل إنَّ “غوغلَ” و”فيسبوكَ” يدرسانِ سلوكياتِنا ليرسمَا خريطةَ العقلِ الجمعيِّ الحديثِ، وكأنما نعيشُ في روايةِ “جورج أورويل” ولكن بلمساتٍ تكنولوجيةٍ!
نقدُ المفهوم: هل هو حقيقةٌ أم وَهْمٌ؟
يقولُ “سيغموند فرويد” ساخرًا: “الجماهيرُ طفلةٌ مدللةٌ تبحثُ عن أبٍ!”. فهل العقلُ الجمعيُّ مجردُ وهمٍ نُخفيه وراءَ سلوكياتِ القطيع؟ أم أنَّه قوةٌ حقيقيةٌ تُشبهُ الجاذبيةَ: لا نراها، لكنَّها تتحكمُ بنا؟
الحقيقةُ أنَّ العلمَ لم يُجزمْ بعدُ، لكنْ يبدو أنَّنا، كبشرٍ، نَميلُ إلى “التماهي مع الجماعة” كطريقةٍ للبقاءِ… حتى لو كلفنا ذلكَ تنازلًا عن فرديتنا!
الخاتمة: هل نَقودُ العقلَ الجمعيَّ… أم يقودُنا؟
في النهاية، يبقى “العقلُ الجمعيُّ” لغزًا مُحيرًا: قوةٌ صامتةٌ تُشكِّلُ أحلامَنا، قراراتِنا، ومصائرَنا. قد نُطلقُ عليه اسمًا علميًّا، لكنَّه في العمقِ يُشبهُ تلكَ الأسطورةَ القديمةَ عن “الوحشِ الجميلِ” الذي ينامُ في أعماقِ كلِّ مجتمعٍ.
فهل نستيقظُه لنبنيَ به عالَمًا أفضلَ؟ أم نتركُه نائمًا لئلا يَفتكَ بنا؟ الجوابُ… بين يديكَ أنت!
المصادر