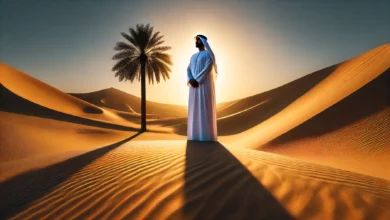تعريف الحداثة: رحلة في أعماق الكلمة التي غيّرت مصير الإنسانية

هل سألتَ نفسك يومًا لماذا نعيش كما نعيش؟ ولماذا تبدو حياتُنا اليومَ مختلفةً جذريًّا عن حياة أجدادنا قبل قرنين فقط؟ إنها الحداثة… ذلك المفهوم الذي انبثق كعاصفةٍ قلبتْ موازينَ التاريخ، فحوّلتِ الإنسانَ من كائنٍ خاضعٍ للأسطورة إلى سيدٍ للعقل والآلة. لكن ما سرُّ هذه الكلمة التي أثارتْ صخبَ الفلاسفة، وألهبتْ صراعاتِ الأدباء، وخلخلتْ ثوابتَ المجتمعات؟ لنغوص معًا في أصلها، ونكتشف معناها، ونستنطق دلالاتها التي ما تزال تُشكّل وعيَنا حتى اللحظة.
الفصل الأول: أصل الكلمة.. من “حَدَثَ” إلى “Modernité”
ككلِّ الثورات العظيمة، بدأت الحداثة بكلمة. كلمةٌ حملتْ في حروفها بذورَ التمرد على كل قديم. ففي العربية، اشتُقتْ “الحداثة” من الجذر “ح د ث”، الذي يُفيد التجديدَ والابتعادَ عن المألوف، كأنها صرخةٌ تقول: “هذا أمرٌ حَدَث، لم يسبق له مثيل!”. أما في الغرب، فقد انطلقتْ من اللفظة اللاتينية “Modernus”، والتي تعني “الحَديث” مقابل “القَديم”، قبل أن تُتوج في القرن التاسع عشر بمصطلح “Modernité” الفرنسي، الذي حمله الشاعر شارل بودلير كشعلةٍ في قصائده، واصفًا إياها بـ”العابر، الهارب، المُتقلب”، كأنه يرى في المراكز الصناعية الصاخبة وجوهًا جديدةً للزمن.
لكنَّ المصطلح لم يصل إلى العالم العربي إلا متأخرًا، كضيفٍ ثقيل يحمل في حقائبه أسئلةً عن الهوية. ففي مطلع القرن العشرين، حاول روادٌ مثل طه حسين وأدونيس تفكيكَ هذه الكلمة، فكتب الأول: “الحداثة ليست خيانةً للتراث، بل هي قراءةٌ جريئةٌ له بعيونٍ لم تعرفِ الخوف”.
الفصل الثاني: المعنى.. عندما يصبح “التجديد” عقيدة
لغويًّا، تظلُّ الحداثةُ مرتبطةً بـ”الحَدَث” و”الابتداع”، لكنَّ اصطلاحًا، تحوّلت إلى مشروعٍ فلسفيٍّ ضخم. فالفيلسوف الألماني يورغن هابرماس يراها “تحررًا للإنسان من سلطة الموروث عبر العقلانية والعلم”، بينما يُلخّصها المفكر المغربي عبد الله العروي بقوله: “هي قطيعةٌ مع الزمن الدائري، ودخولٌ إلى زمن التقدّم الخطي”.
لكنَّ الحداثةَ لم تكن مجرد تنظيرٍ فلسفي، بل كانت ثورةً ملموسة:
- في الأدب: تمرد بودلير على القصيدة الكلاسيكية، وابتكر قصيدةَ النثر.
- في الفن: تحطيم بيكاسو لقواعد المنظور، ورسمُه وجوهًا مشوّهةً تعكس اضطرابَ الإنسان الحديث.
- في المجتمع: صعودُ الفردانية، وتقلصُ سلطة الكنيسة، وولادةُ “حقوق الإنسان” كدينٍ جديد.
الفصل الثالث: الدلالات.. وجهٌ فلسفيٌّ، ووجهٌ اجتماعيٌّ، ووجهٌ فنيٌّ
كالجوهرة متعددة الأوجه، تُظهر الحداثةُ دلالاتٍ مختلفةً بحسب الزاوية التي تُنظر منها:
1. الدلالة الفلسفية: العقل إلهًا جديدًا
بعد قرونٍ من حُكم اللاهوت، أعلن ديكارت أنَّ “الكوجيتو” –أي “أنا أفكر، إذن أنا موجود”– هو أساسُ الحقيقة. ثم جاء كانط ليرسم حدودَ العقل، لكنه مع ذلك جعل منه سلطةً مطلقة. هكذا أصبحتِ الحداثةُ مرادفةً للتفكير النقدي، حيث لا شيء يُقدس إلا المنطق.
2. الدلالة الاجتماعية: تفكيك القبيلة
لم تعد الأسرةُ الممتدةُ أو العشيرةُ هي نواة المجتمع، بل الفردُ المستقل. وصارتِ المدنُ الكبرى مختبراتٍ لهذا التحول، حيث يذوب الإنسانُ في الزحام، ويشتري سعادته ببطاقة ائتمان. حتى الدين لم يسلم: فالعلمانيةُ –ابنة الحداثة الشرعية– فصلتِ الدولةَ عن الكنيسة، وحوّلتِ الأخلاقَ إلى قوانينَ وضعية.
3. الدلالة الفنية: ثورة الألوان والكلمات
في الشعر العربي، ثار أدونيس على القصيدة العمودية، داعيًا إلى “قصيدة النثر” التي تحمل إيقاعَ الزمن الحديث. وفي العمارة، سقطتِ الأعمدةُ اليونانيةُ العتيقة، وحلَّ مكانَها الزجاجُ والفولاذُ في ناطحات السحاب، كأنما الإنسانُ يقول للسماء: “لن أركعَ بعد اليوم!”.
الفصل الرابع: النقد.. هل كانت الحداثة خطيئة؟
لكل ثورةٍ ضحاياها. فمن ينتقدون الحداثة يرون أنها:
- قطعتْ صلةَ الإنسان بجذوره الروحية، وحوّلته إلى آلةٍ تنتج وتستهلك.
- دمّرتِ البيئةَ باسم التقدّم، وأفرزتْ حروبًا عالميةً باستخدام تقنياتها.
- في العالم العربي، اتُّهمتْ بالتبعية للغرب، كما كتب المفكر عبد الوهاب المسيري: “الحداثةُ الغربيةُ كالنهر الجارف، إما أن تُسبح مع تياره أو تُغرق”.
لكن المدافعين عنها يرون أنها:
- خلّصتِ الإنسانَ من الخرافة، وفتحتْ له آفاقَ الحرية.
- في الأدب العربي، أثبت نجيب محفوظ في روايته “أولاد حارتنا” أنَّ الحداثةَ لا تعني القطيعةَ مع التراث، بل إعادةَ إنتاجه بلسان العصر.
الفصل الخامس: الحداثة العربية.. هل نعيش أزمةَ مفاهيم؟
لماذا تشعرُ أنَّ الحداثةَ في العالم العربي أشبه ب”طفلٍ حافي القدمين يرتدي بدلةً أوروبية”؟ الإجابة تكمن في الإشكالية التي طرحها المفكر محمد عابد الجابري: “كيف نستورد آلةَ الغرب الحديثة دون أن نستوردَ رؤيتَه للعالم؟”.
لقد حاولت النخبُ العربيةُ منذ القرن التاسع عشر التوفيقَ بين “معنى الحداثة” والهوية، فأنتجتْ تناقضاتٍ واضحة:
- في التعليم: ندرسُ علومَ الغرب، لكننا نحفظُ أبناءنا القرآنَ بنفس طريقة الأجداد.
- في السياسة: نتبنى الديمقراطيةَ شكليًّا، بينما تظلُّ العصبيةُ القبليةُ هي اللعبة الحقيقية.
الخاتمة: الحداثة.. مشروعٌ لم يكتمل بعد
في النهاية، يظلُّ “تعريف الحداثة” سؤالًا مفتوحًا. فهل نستطيع –نحن أبناء الشرق– أن نصنعَ حداثةً لا تنكر ماضينا، ولا تخون إنسانيتنا؟ ربما تكون الإجابة عند الشاعر أدونيس، الذي رأى أنَّ “الحداثةَ الحقيقيةَ هي التي تُحوّل التراثَ من تابوتٍ إلى بذرة”. فلننظرْ إلى الحداثةِ إذن كرحلتنا نحو ذواتنا، لا هروبًا منها.
المصادر :
- “حداثة غير مكتملة” – هشام جعيط (دار الطليعة، 1991).
- الحداثة وما بعد الحداثة بين المسيري والتريكي .. بقلم : د.احمد عبدالحليم عطية
- “الحداثة والتحديث” – عبد الله العروي (المركز الثقافي العربي، 2010).
- “المشروع النهضوي العربي” – محمد عابد الجابري (مركز دراسات الوحدة العربية، 1999).
- “الخطاب العربي المعاصر” – جورج طرابيشي (دار الساقي، 2002).
- “The Philosophical Discourse of Modernity” – Jürgen Habermas (MIT Press, 1990).