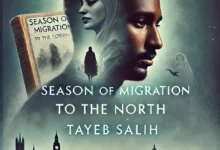ملخص رواية “عزازيل” ليوسف زيدان
رواية "عزازيل" ليوسف زيدان: رحلة فلسفية في دهاليز الإيمان والشك

ليست الروايةُ مجرد سردٍ لأحداثٍ ماضية، بل هي حفرٌ في طبقاتِ الزمنِ بحثًا عن جوهرِ الإنسان الذي لم يتغيرْ. هكذا تأخذنا “عزازيل” – للكاتب المصري يوسف زيدان – إلى القرن الخامس الميلادي، لا لنشهدَ صراعاتِ الكنيسةِ واختلافاتِها اللاهوتية فحسب، بل لنعيشَ مع هيبا، الراهبِ المصري، رحلةً وجوديةً تطرحُ أسئلةً ما زالَ صداهَا يُقلقُنا اليوم: أين يلتقي الشكُّ بالإيمان؟ وهل يُمكن للعقلِ أن يُصغي إلى نداءِ الروحِ دون خيانةٍ لأحدهما؟
هذه الروايةُ، التي فازت بالجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) عام 2009، لم تكن حدثًا أدبيًا عابرًا، بل زلزالًا هزَّ أركانَ الخطابِ الديني والأدبي معًا. فهي تتعمقُ في المناطقِ المظلمةِ من التاريخِ، وتكشفُ عن صراعاتِ الإنسانِ التي تعلو فوقَ حدودِ الزمانِ والمكانِ.
الفصل الأول: ملخص الرواية – حين يتناثرُ المخطوطُ كشظايا روح
تدورُ الأحداثُ حولَ مخطوطاتٍ قديمةٍ وُجدت – بحسبِ الرواية – في اكتشافٍ أثريٍّ بالقربِ من حلب، تروي سيرةَ الراهبِ هيبا (الذي يُنادى لاحقًا أبّا هيبا) في القرنِ الخامسِ الميلادي، بعد انعقادِ مجمع أفسس الذي حسمَ الخلافَ حولَ طبيعةِ المسيحِ.
يبدأُ هيبا رحلتَه من صعيد مصر، حيثُ ينشأُ في كنفِ أمٍّ تموتُ مسمومةً، ليهربَ من ظلمِ الواقعِ إلى حياةِ الرهبنةِ. لكنَّ هروبهَ لا يُطفئُ ظمأَهُ إلى المعرفةِ، فيرحلُ إلى الإسكندرية، ثم إلى أنطاكيا، حيثُ يَشهدُ صراعاتِ الكنيسةِ بين مذهبي الطبيعة الواحدة والنسطورية، ويَقعُ في حبِّ أوكتافيا، المرأةِ التي تُمثلُ لهُ جسرًا بين العاطفةِ المُحرَّمةِ والعقلِ المُكبَّلِ.
عبرَ المخطوطاتِ، يسردُ هيبا حواراتِه مع عزازيل – ذلك الصوتِ الداخليِّ الذي يجسدُ إغراءَ الشكِّ – في محاولةٍ لفهمِ طبيعةِ اللهِ والشرِّ، بينما تتآكلُ يقينياتُه شيئًا فشيئًا، ليصيرَ سؤالُهُ الأبديُّ: “أين الحقيقةُ؟”.
الفصل الثاني: شخصيات الرواية – أطيافٌ من التناقضِ الإنساني
1. هيبا (أبّا هيبا): الراهبُ الذي حملَ جرحَ السؤالِ
ليس هيبا بطلًا تقليديًا، بل إنسانٌ هشٌّ، يحملُ في داخلهِ نارَ الشكِّ وبرودةَ الإيمانِ. نشأتُه المليئةُ بالآلامِ – موتُ أمهِ الظالمُ – جعلتْ من الرهبنةِ ملاذًا، لكنَّها لم تكن سوى قفصًا لأسئلتِه. رحلتُه بين المدنِ تَكشفُ تحوُّلَهُ من راهبٍ مُطيعٍ إلى فيلسوفٍ يبحثُ عن الحقيقةِ في ظلالِ الشكِّ.
2. عزازيل: الشيطانُ الذي يُشبهنا
عزازيل ليس كائنًا شريرًا تقليديًا، بل هو تجسيدٌ لاللاوعي الإنساني، صوتٌ يُذكِّرُ هيبا بأنَّ الشكَّ هو بدايةُ الحكمةِ. يقولُ له: “أنا لستُ عدوَّك، أنا صوتُك الذي تُخفيْتُه تحتَ رداءِ الإيمانِ”. هذا الحوارُ الداخليُّ يُجسِّدُ الصراعَ الأبديَّ بين ما نعتقدُ أننا نريده، وما نريدهُ حقًا.
3. أوكتافيا: المرأةُ التي هزَّتْ عرشَ اليقينِ
أوكتافيا ليست مجردَ امرأةٍ أحبَّها هيبا، بل هي رمزٌ لالحريةِ المكبوتةِ في مجتمعٍ يرى في الجسدِ خطيئةً. حبُّه لها ليسَ شهوةً عابرةً، بل بحثٌ عن الإلهِ في ملامحِ الإنسانِ. يقولُ هيبا: “في عينيها رأيتُ اللهَ يُحبُّ نفسَهُ”.
4. نسطور: المُفكِّرُ الذي تحوَّل إلى هرطوقٍ
الشخصيةُ التاريخيةُ نسطور – بطريرك القسطنطينية – تُقدَّم في الرواية كضحيَّةِ صراعِ السلطةِ داخلَ الكنيسةِ. يُصوِّرُهُ زيدانَ ليس كمنحرفٍ، بل كفيلسوفٍ تجرأَ على طرحِ أسئلةٍ تُزعزعُ اليقينَ الدينيَّ.
الفصل الثالث: السياق التاريخي – حين يُصبحُ اللاهوتُ ساحةً للدمِ
تعتمدُ الروايةُ على خلفيةٍ تاريخيةٍ دقيقةٍ، هي فترةُ القرن الخامس الميلادي، التي شهدتْ حروبًا عقائديةً بين فِرقِ المسيحيةِ حولَ طبيعةِ المسيحِ:
- النسطورية: تؤكدُ على طبيعتَيْن منفصلتَيْن للمسيحِ (إلهيةٌ وبشريةٌ).
- الطبيعة الواحدة: ترى أنَّ للمسيحِ طبيعةً واحدةً تجمعُ بين الإلهي والبشري.
في هذا الجوِّ، يُصوِّرُ زيدانُ مجمع أفسس (431 م) كمثالٍ على تحوُّلِ الخلافِ الفكريِّ إلى صراعٍ دمويٍّ، حيثُ يُحرَقُ المعارضونَ، وتُبادُ المذاهبُ المخالفةُ. الروايةُ تَكشفُ كيفَ أنَّ التاريخَ الدينيَّ – رغم قداستِه – لم يكنْ إلا ساحةً لصراعِ النفوذِ بين البشرِ.
حريق مكتبة الإسكندرية: رمزيةُ قتلِ المعرفةِ
في مشهدٍ مُؤثرٍ، تَروي الروايةُ حرقَ مكتبةِ الإسكندريةِ – الواقعةَ التاريخيةُ المثيرةُ للجدلِ – كرمزٍ لتدميرِ الفكرِ المختلفِ. يقولُ هيبا: “النارُ لا تأكلُ الورقَ، بل تأكلُ عيونَ الذين يقرأونَهُ”.
الفصل الرابع: الأفكار الرئيسية – أسئلةٌ تعلو فوقَ الزمنِ
1. الشكُّ طريقًا إلى الإيمانِ
الروايةُ ترفضُ الفصلَ البسيطَ بين الإيمانِ والشكِّ؛ فالشكُّ عندَ هيبا ليسَ كفرًا، بل محاولةٌ لفهمِ الإلهِ بعيدًا عن догماتِ الكنيسةِ. يقولُ عزازيلُ له: “الإيمانُ الذي لا يهتزُّ لا يستحقُّ اسمَ إيمانٍ”.
2. العقلُ والروحُ: صراعٌ أم تكاملٌ؟
تطرحُ الروايةُ إشكاليةَ العلاقةِ بين العقلِ المادي والروحِ المتطلعةِ إلى المطلقِ. هيبا – الطبيبُ الذي درسَ علومَ التشريحِ – يُدركُ أنَّ الجسدَ مادةٌ، لكنَّهُ يبحثُ عن روحٍ تُفسرُ وجودَ هذه المادةِ.
3. المرأةُ: الخطيئةُ والقداسةُ
أوكتافيا ليستْ مجردَ إغراءٍ جسديٍّ، بل هي تمثيلٌ لالأنوثةِ المُقدسةِ التي تُحرِّرُ العقلَ من سجنِ التقاليدِ. حبُّ هيبا لها هو محاولةٌ لعبورِ الهوةِ بين الجسدِ (الذي تراهُ الكنيسةُ دنسًا) والروحِ (التي تراها طاهرةً).
4. إعادةُ كتابةِ التاريخِ: من يملكُ الحقَّ في روايةِ الماضي؟
الروايةُ تَكشفُ أنَّ التاريخَ – خاصةً الدينيَّ – كُتِبَ بأيدي المنتصرينَ. فشخصيةُ القديس كيرلس – الذي يُصوَّرُ في التاريخِ الكنسيِّ كبطلٍ – تظهرُ في الروايةِ كقائدٍ متعصبٍ يُشعلُ الحروبَ ضدَّ المختلفينَ.
الفصل الخامس: الجدلُ – حين يَصطدمُ الأدبُ بالمحظورِ
واجهتْ “عزازيل” هجومًا شرسًا من بعضِ الأوساطِ الدينيةِ المسيحيةِ، التي اتهمتْ زيدانَ بـ:
- تشويهِ شخصياتٍ تاريخيةٍ مقدسةٍ (مثل القديس كيرلس).
- الترويجِ لأفكارٍ ماديةٍ تُقللُ من قدسيةِ الإيمانِ.
- استخدامِ التاريخِ كأداةٍ لنقدِ الأديانِ.
في المقابل، دافعَ مفكرونَ ونقادٌ عن حقِّ الروايةِ في استكشافِ المناطقِ الرماديةِ، مؤكدينَ أنَّ الأدبَ ليسَ وثيقةً لاهوتيةً، بل فضاءً للتساؤلِ. يقولُ زيدانُ في إحدى مقابلاتِه: “لم أكتبْ عزازيلَ لأهدمَ إيمانًا، بل كتبتُها لأسألَ: كيفَ نؤمنُ؟”.
الفصل السادس: لماذا تظلُّ “عزازيل” عملًا أدبيًا فريدًا؟
1. لغةٌ تلامسُ العمقَ دون تكلُّفٍ
يمزجُ زيدانُ بين لغةٍ سرديةٍ سلسةٍ وأسلوبٍ فلسفيٍّ عميقٍ، مُستحضرًا أجواءَ القرنِ الخامسِ عبرَ مفرداتٍ تُحاكي لغةَ المخطوطاتِ القديمةِ، دون أن تفقدَ سلاسةَ الحكيِّ.
2. الجرأةُ في كسرِ التابوهاتِ
كسرتِ الروايةُ حاجزَ الصمتِ حولَ نقاشِ الدينِ في الأدبِ العربيِّ، مقدمةً نموذجًا لروايةِ الأفكارِ التي لا تخشى المواجهةَ.
3. البُعدُ الإنسانيُّ فوقَ الأيديولوجياتِ
الروايةُ لا تنحازُ إلى الإيمانِ أو الشكِّ، بل تُقدِّمُ هيبا كإنسانٍ قبلَ أن يكونَ راهبًا أو فيلسوفًا. صراعُهُ هو صراعُ كلِّ مَنْ يبحثُ عن معنى في عالمٍ مليءٍ بالتناقضاتِ.
الخاتمة: عزازيل… رسالةُ الشكِّ إلى الإنسانِ الحديثِ
ربما يكونُ الدرسُ الأكبرُ لـ”عزازيل” هو أنَّ الشكَّ ليس عدوًّا للإيمانِ، بل هو ضرورةٌ لِإيمانٍ أعمقَ. الروايةُ، برغمِ جدلِها، تفتحُ نافذةً للحوارِ بين الأديانِ والفلسفاتِ، وتُذكِّرُنا بأنَّ الأسئلةَ – وليسَ الأجوبةَ – هي ما يُحرِّكُ الإنسانيةَ نحوَ الحقيقةِ.
في النهاية، ليستْ “عزازيل” روايةً عن القرنِ الخامسِ، بل عنا نحنُ – أبناءِ القرنِ الحادي والعشرينَ – الذين ما زلنا نُصارعُ ذاتَ الأسئلةِ: كيفَ نؤمنُ؟ ولماذا نشكُّ؟ وأينَ يلتقي طريقُ العقلِ بِطريقِ الروحِ؟