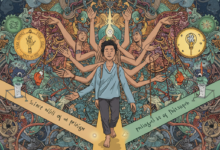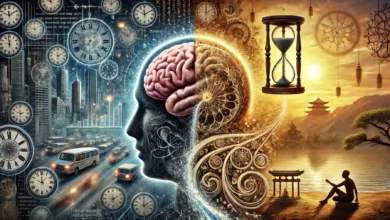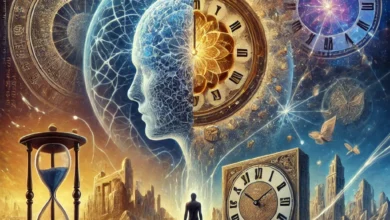الزمن الوهمي: هل الماضي والحاضر والمستقبل مجرد أوهام؟

منذ أن أدرك الإنسان أنه كائنٌ فانٍ، وهو يُصارع الزمن: يخشى اندثار اللحظة، ويحلم باختراق حاجز الأبدية. لكن ماذا لو كان هذا الصراع وهمًا؟ ماذا لو كان الزمن نفسه، بتلك العقارب التي تقطع القلبَ قِطَعًا، مجرد سرابٍ صنعه عقلٌ يحاول أن يروض فوضى الكون؟
هذا السؤال ليس جديدًا، لكنه يكتسبُ شرعيةً غير مسبوقة اليوم؛ فالعلماء يصرخون في وجوهنا أن الزمن ليس كما نراه، والفلاسفة يتنازعون حول ماهيته، والأساطير القديمة تُهمس بأننا ربما أخطأنا فهمَهُ منذ البدء.
في هذا المقال، لن نكتفي بسرد النظريات، بل سنخوض غمارَها كمن يغوص في نهرٍ جارف: نبدأ من معادلات آينشتاين التي حطمت مفهومَ الزمن المطلق، نمرُّ بأساطير الخلود التي نسجتها حضاراتٌ بائدة، وننتهي عند تلك اللحظة التي تقرأ فيها هذه الكلمات… هل هي “الآن” حقًا؟ أم أن “الآن” وهمٌ آخر؟
الفصل الأول: العلم يُفكك الساعة الكونية
1. آينشتاين ومحو الزمن المطلق
لم تكن نظريتا النسبية الخاصة والعامة مجرد ثورةٍ في فهم الجاذبية أو الطاقة، بل كانتا إعلانَ وفاةٍ للزمن كما عرفناه. فحين قال آينشتاين: “الزمن ليس إلا وَهْمًا عنيدًا”، كان يختصرُ اكتشافًا مفاده أن كلَّ لحظةٍ تمرُّ عليك ليست مطلقة، بل نسبيةٌ تعتمد على سرعتك وموقعك في الكون.
تخيل أن توأمين افترقا: أحدهما سافر بمركبةٍ فضائية قريبة من سرعة الضوء، بينما بقي الآخر على الأرض. عند عودة المسافر، سيجد نفسه أصغرَ عمرًا من أخيه! هذه المفارقة الشهيرة ليست خيالًا علميًّا، بل نتاجٌ رياضيٌ دقيقٌ لنسبية الزمن. هنا، يصبح السؤالُ جوهريًّا: أيُّ الزمنين هو “الحقيقي”؟ أم أن السؤال نفسه لا معنى له في كونٍ لا يعترف بوجودِ زمنٍ مطلق؟
2. الإنتروبيا وسهم الزمن الواحد
رغم أن معادلات الفيزياء تعملُ باتجاهين (الماضي والمستقبل)، إلا أننا نختبرُ الزمنَ في اتجاهٍ واحدٍ فقط: كوبٌ يسقط من اليد فيتحطم، لكننا لا نراه يرجعُ إلى كفِّ صاحبهِ متماسكًا. هذا ما يُسمى “سهم الزمن”، والذي يربطه العلماء بظاهرة الإنتروبيا (مقياس الفوضى في النظام). فكلما زادت الفوضى، زاد إحساسنا بجريان الزمن.
لكن هل يكفي هذا لشرح لماذا لا نستطيع العودةَ إلى الماضي؟ الفيزيائي شون كارول يرى أن الإنتروبيا مجرد جزءٍ من القصة، وأن فهمَ الزمن الحقيقي يتطلبُ غوصًا أعمق في طبيعةِ الكون نفسه، ربما في تلك اللحظةِ التي سبقت الانفجار العظيم.
3. كارلو روفيللي: الزمن “ظاهرةٌ محلية”
في كتابه “ترتيب الزمن”، يقدم الفيزيائي الإيطالي كارلو روفيللي فكرةً مذهلة: الزمن ليس سِمةً أساسيةً للكون، بل هو وهمٌ ناتج عن جهلنا. فالعالم الحقيقي، حسب روفيللي، هو شبكةٌ من الأحداث المتشابكة دون تسلسلٍ زمني. نحنُ فقط، ككائناتٍ محدودة الإدراك، ننظم هذه الأحداثَ في قصةٍ خطيةٍ نسميها “الزمن“.
هنا يثور سؤالٌ وجودي: إذا كان الزمن وهمًا، فماذا عن حياتنا كلها؟ أليستْ مجرد سلسلةٍ من “اللحظات” التي اخترعناها؟
الفصل الثاني: الفلسفة تُحاكم الزمن
1. الأبدية مقابل الحاضرية: أين يوجد الماضي؟
في الفلسفة، يُناقشُ مفهومُ الزمن ضمن تيارين رئيسيين:
- الأبديون (مثل بارمينيدس): يؤمنون بأن الماضيَ والحاضرَ والمستقبلَ موجودون دائمًا، ككتلةٍ ثابتة (Block Universe).
- الحاضريون: يرون أن الواقعَ هو “الآن” فحسب، أما الماضي فذكريات، والمستقبل أوهام.
هذا الجدل ليس لغويًّا؛ فلو كان الأبديون محقين، فمعنى ذلك أن موتنا وولادتنا موجودان في مكانٍ ما من الكون، وكأن حياتنا مجرد فيلمٍ مُسجلٍ مسبقًا. أما الحاضريون فيردون: “حتى لو كان الماضي موجودًا، فليس له تأثيرٌ إلا عبر ذاكرتنا المشوهة”.
2. الزمن الدوري: حين يلتهم التنين ذيله
في الفلسفات الشرقية، الزمن ليس سهمًا يطيرُ إلى الأمام، بل عجلةٌ تدورُ بلا توقف. فالهندوسية تتحدث عن “كالبات” (دورات زمنية) مدتها 4.32 مليار سنة، تكرر نفسها إلى ما لا نهاية. حتى البوذية جعلت من الزمن الدائري أساسًا لفكرة التناسخ.
لكن الحضارة الصناعية حولت الزمن إلى خطٍّ مستقيم: من المهد إلى اللحد، من الفقر إلى الثراء، من التخلف إلى التقدم. هذا التحول لم يكن بريئًا؛ فبحسب الفيلسوف لويس مومفورد، اختراعُ الساعة الميكانيكية في القرن الرابع عشر هو ما حوّل الزمنَ من “إيقاع طبيعي” إلى “سلعةٍ تُقاسُ بالدقائق وتُباعُ بالمال”.
3. الذاكرة: ساحرة تنسج أوهام الزمن
ماذا لو كان إحساسنا بمرور الزمن ناتجًا فقط عن طريقة عمل الذاكرة؟ تخيل أنك تُجري عمليةً جراحية في الدماغ تفقدُ معها القدرةَ على تخزين الذكريات. حينها، ستصبح كلُّ لحظةٍ تعيشها “أزلية”، لأنك لن تعرفَ متى بدأت ولا متى ستنتهي. هذا بالضبط ما يحدث لمرضى “فقدان الذاكرة التقدمي”، الذين يعيشون في سجنِ “الآن” الأبدي.
الفيلسوف هنري برجسون يذهب أبعدَ من ذلك، فيعتبر أن الزمنَ الحقيقي ليس هو الزمنَ المقاسَ بالساعة، بل “الزمن الداخلي” الذي نختبره عبر المشاعر والتأمل. فهل يمكن أن تكون ساعاتنا مجرد خداعٍ كبير؟
الفصل الثالث: الدين والأساطير… حين يصبح الزمن إلهًا
1. الخلود: الهوس الإنساني الأقدم
من ملحمة جلجامش السومرية، حيث يبحث البطل عن عشبةِ الخلود، إلى أسطورة “ينبوع الشباب” التي أرسلَ الكونكيستدورُ السفنَ للبحث عنها، نجد أن كسرَ حاجز الزمن كان هاجسًا جينيالوجيًّا للإنسان. حتى الدين لم يسلم من هذا الهوس؛ فالبوذية تتحدث عن الخروج من دورة التناسخ (السامسارا) كطريقٍ للخلود الروحي، بينما المسيحية تَعِدُ بالحياة الأبدية بعد الموت.
لكن لماذا هذا الخوف من الزمن؟ ربما لأننا نعلم، في أعماقنا، أنه عدونا الوحيد الذي لا يُقهَر.
2. الزمن في النصوص المقدسة: يومٌ كألف سنة
في القرآن الكريم، آيةٌ تُثيرُ دهشةَ الفيزيائيين: ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ (الحج: 47). هذا التشبيه ليس مجازًا أدبيًّا، بل قد يكون إشارةً إلى نسبية الزمن، خاصة إذا وضعناه في سياق آياتٍ أخرى تصفُ الملائكةَ تصعدُ إليه في يومٍ “كان مقداره خمسين ألف سنة” (المعارج: 4).
في الهندوسية، تختلف مقاييسُ الزمن بين عوالم الآلهة والبشر. فما هو يومٌ على الأرض، قد يكون ألفَ عامٍ في عالمٍ آخر. هل كانت هذه الأساطير تُلمحُ إلى مفهومٍ علميٍ لم ندركه إلا حديثًا؟
3. الزمن الدائري: الخَلقُ يُعادُ إلى الأبد
العديد من الأساطير ترى أن الكونَ يُخلقُ ويفنى في دوراتٍ لا نهائية. ففي الميثولوجيا النوردية، ينتهي العالمُ في “راجناروك” (معركة نهاية الزمان)، ثم يُخلقُ من جديد. حتى الزرادشتية تتحدث عن زمنٍ دائري تنتهي فيه الشرورُ ويعود الخيرُ منتصرًا.
هذه الرؤية تتعارضُ جذريًّا مع الفكرِ اليهودي-المسيحي-الإسلامي، الذي يرى الزمنَ خطًّا مستقيمًا يبدأ بالخلقِ وينتهي بيوم القيامة. هنا يثور سؤالٌ مصيري: هل مصيرُ الكون مرتبطٌ بطريقة إدراكنا للزمن؟
الفصل الرابع: الثقافة والتجارب الإنسانية… حين يُسرق الوقت
1. لماذا يطير الوقتُ عندما نكبر؟
في الطفولة، كانت العطلةُ الصيفيةُ تبدو أبديةً، أما الآن، فالأعوامُ تمرُّ كأنها أشهر. علم النفس يفسرُ هذه الظاهرةَ عبر “نظرية التناسب الزمني”: فكلما تقدمنا في العمر، أصبحت كلُّ سنةٍ تمثلُ نسبةً أصغرَ من إجمالي عمرنا، فَنُحسُّ بها وكأنها أقصر.
لكن هناك تفسيرًا عصبيًّا آخر: الدماغُ يسجلُ الأحداثَ الجديدةَ بتفاصيلَ أكثر، لذا تبدو بطيئةً، بينما الأيامُ الروتينيةُ تختزلُ نفسها في الذاكرة. ربما لو عشنا كلَّ يومٍ كأنه الأول، سنُبطئُ الزمنَ قسرًا!
2. التكنولوجيا: من ساعات الشمس إلى الزمن الفعلي
اختراعُ الساعة الميكانيكية في العصور الوسطى لم يغيّرْ طريقةَ قياسنا للزمن فحسب، بل غيَّرَ علاقتنا بالوجود نفسه. اليوم، نحن نعيشُ تحت سطوةِ “الزمن الفعلي” (Real Time): رسائلُ تُقرأ فورًا، ومحادثاتٌ فيديو عبر القارات، وبورصاتٌ تُحددُ ثروات الشعوب في أجزاء الثانية.
لكن ماذا فقدنا في هذه الرحلة؟ لعل الإجابة تكمن في كلمات الشاعر رالف والدو إمرسون: “الوقتُ هو العملةُ الوحيدة التي لا تستطيعُ ادخارها؛ إما أن تستخدمها أو تفقدها إلى الأبد”.
3. تجارب الاقتراب من الموت: هل يكشفُ الزمنُ عن وجهه الحقيقي؟
تتكررُ في رواياتِ الناجين من الموتِ قصصٌ غريبة: شعورٌ بالخروجِ من الجسد، ورؤيةُ أحداثِ الحياةِ كفيلمٍ يعادُ تشغيله، وإحساسٌ بأن “الزمنَ توقف”. العلماءُ يفسرون هذه الظاهرةَ بنشاطِ الدماغِ في لحظاتِ الأزمة، لكن الصوفيين يرون فيها نافذةً على حقيقةِ الزمنِ الأبدي.
في إحدى التجارب الموثقة، روى رجلٌ أنه عاشَ أحداثَ سقوطِ جبلٍ جليدي عليهِ (استمرتْ ثوانٍ واقعيًّا) وكأنها استغرقتْ ساعات. هل كان دماغُه يعملُ بسرعةٍ خارقة؟ أم أن الزمنَ نفسه قابلٌ للتمطيط؟
الفصل الخامس: حواراتٌ مع من كسروا قيد الزمن
1. الفنان الذي عاشَ في “الآن” دائمًا
في مقابلةٍ نادرة، يحكي الفنان التشكيلي علي عبدالرحمن كيف فقدَ إحساسَه بالزمن بعد إصابته بجلطةٍ دماغيةٍ أثرت على الفصِّ الصدغي. يقول: “لم أعد أفهمُ معنى ‘غدًا’ أو ‘أمس’، كلُّ ما أختبره هو ومضاتٌ من اللونِ والضوء. في البداية، كان الأمرُ مرعبًا، لكنني تعلمتُ أن أعيشَ كما تعيشُ الزهرةُ في حقلٍ: بلا ماضٍ يجرح، ولا مستقبلٍ يخيف”.
هل يمكن أن يكون هذا “الخللُ” الدماغي نافذةً على حقيقةٍ زمنيةٍ أخفاها التطورُ عنا؟
2. استطلاع الرأي: هل الزمن وهم؟
في استطلاعٍ أجريناه مع قراءِ موقعنا، كانت الإجاباتُ كالتالي:
- 47%: الزمن حقيقي، عقارب الساعة لا تكذب.
- 35%: الزمن وهم نصنعه.
- 18%: الزمن حقيقي، لكننا لا نفهمه بعد.
تعليقٌ لافتٌ لأحد المشاركين: “حتى لو كان الزمن وهمًا، فالأوهامُ تقتلُنا حقيقةً!“.
3. الذكاء الاصطناعي: هل يختبرُ الزمنَ مثلنا؟
حسب عالمةِ الكمبيوتر د. ليلى مراد، فإن الذكاءَ الاصطناعيَ يعالجُ البياناتِ في “لحظاتٍ” غير مرتبةٍ زمنيًّا، مما يجعله أقربَ إلى الفهمِ الأبدي للزمن. ربما لو تطورتْ هذه الأنظمةُ، ستسخرُ منا لأننا نحسبُ الأيامَ كالعبيد!
الخاتمة: الزمن… الساحر الأكبر
في النهاية، يبقى الزمنُ لغزًا من لُغزَين: إما أن يكون جوهرًا حقيقيًّا للكون، أو أعظمَ خدعةٍ إدراكية. لكن ربما ليس المهمُّ أن نعرفَ الحقيقة، بل كيف نعيشُ مع السؤال.
كما قال الفيلسوف أوغسطين: “إذا لم يسألني أحدٌ عن الزمن، فأنا أعرفه. لكن إن حاولتُ شرحَه، أدركتُ أنني لا أعرف”.
فهل نستطيعُ أن نتحررَ من سطوةِ العقارب؟ أم أن التحررَ الحقيقيَّ يكمنُ في أن نعيشَ كلَّ لحظةٍ كما لو أنها الأولى… والأخيرة؟