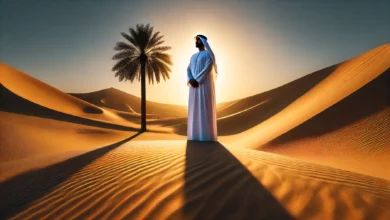مفهوم الفن: فسحة في أعماقِ الجمالِ والإبداعِ الإنسانيِّ

هل يكفي أن نُعرِّفَ الفنَّ بأنه لوحةٌ تُعلَّقُ على الجدار، أو تمثالٌ يُزيِّنُ الساحة؟ أم هو ذلك الهمسُ الخالدُ الذي ينطلقُ من أعماقِ الإنسانِ لِيَحْمِلَ في طياتِه أسرارَ الوجودِ والجمال؟ إنَّ الفنَّ، في جوهرِه، لغةٌ لا تُترجَمُ بكلماتٍ، بل تُفهمُ بالقلبِ، وتُحسُّ بالروحِ. إنه المرآةُ التي تعكسُ أحلامَ الشعوبِ، وآلامَها، وحكاياتِها التي لا تنتهي. فتعالَوا نغوصُ معًا في أصولِ هذه الكلمةِ، ونكتشفُ معانيها التي تخطَّتِ الزمانَ والمكانَ.
الفصل الأول: أصلُ الكلمةِ.. مِنَ الحرفيةِ إلى الإبداعِ
في رحابِ اللغةِ العربيةِ
إذا عدنا إلى المعاجمِ العربيةِ العتيقةِ، نجدُ أنَّ كلمةَ “الفنِّ” تُشتقُّ من الجذرِ “فَنَنَ”، الذي يحملُ في طياتِه معنى الإتقانِ والبراعةِ. ففي “لسانِ العربِ” لابنِ منظورٍ: “الفَنُّ: الحيلةُ، وَالفَنُّ: الضربُ مِنَ الصّنْعَةِ”. وكان العربُ يصفونَ الرجلَ “المُتفنِّنَ” بأنه مَنْ أتقنَ صنعةً ما، سواءً أكانتْ نحتًا أو شعرًا. لكنَّ المفهومَ تطوَّرَ لاحقًا لِيُعبِّرَ عن كلِّ إبداعٍ يخترقُ المألوفَ.
عندَ الإغريقِ والرومانِ.. حيثُ وُلدَتِ الكلمةُ
أما الأصلُ اللاتينيُّ للكلمةِ “Ars” واليونانيُّ “Τέχνη” (تيكني)، فكانا يُشيرانِ إلى المهارةِ الصناعيةِ أو الحرفيةِ. فالنحاتُ عندَ أرسطو كانَ “صانعًا” قبلَ أن يكونَ “فنانًا”. لكنَّ المنعطفَ الحاسمَ جاءَ مع عصرِ النهضةِ، حينَ تحوَّلَ الفنُّ مِنْ حرفةٍ إلى رسالةٍ. يقولُ إرنست غومبرتش في كتابِه “تاريخُ الفنِّ”: “لم يعُدِ الفنانُ مجردَ عاملٍ، بل صارَ نبيًّا يُعلِنُ عن حقائقَ لا تُرى”.
الفصل الثاني: تعريفُ الفنِّ.. بينَ الفلسفةِ والعلمِ
عندَ الفلاسفةِ: مِنْ أفلاطونَ إلى هيغلَ
حاولَ الفلاسفةُ عبرَ العصورِ الإمساكَ بتعريفِ الفنِّ، لكنَّه ظلَّ كالفراشةِ تَنْفَلِتُ مِنْ بينِ الأصابعِ. رأى أفلاطونُ أنَّ الفنَّ “محاكاةٌ للواقعِ”، لكنَّ كانطَ ثارَ على هذه الفكرةِ، فوصفَ الفنَّ بأنه “جمالٌ بلا غايةٍ“، أيْ أنَّ قيمتَه تكمنُ في ذاتِه. أما هيغلُ، فذهبَ إلى أنَّ الفنَّ “تعيينٌ لروحِ العصرِ”، فهو يعكسُ رؤيةَ المجتمعِ للعالمِ.
عندَ العلماءِ: الفنُّ كَنافذةٍ على اللاوعيِ
وفي العصرِ الحديثِ، حاولَ علمُ النفسِ فكَّ شفراتِ الفنِّ. رأى فرويدُ أنَّ الأعمالَ الفنيةَ “أحلامٌ يقظةٍ” تُعبِّرُ عن رغباتٍ مكبوتةٍ، بينما اعتبرَ كارل يونغ أنَّها تجسيدٌ للأساطيرِ الجماعيةِ التي تسكنُ لاوعيَ البشرِ. هكذا، أصبحَ الفنُّ جسرًا بينَ العالمِ الظاهرِ والخفيِّ.
الفصل الثالث: دلالاتُ الفنِّ.. مِنْ الكهوفِ إلى الثوراتِ
الفنُّ كشاهدٍ على الحضاراتِ
لننظرْ إلى رسومِ الكهوفِ في لاسكو بفرنسا، حيثُ رسمَ إنسانُ ما قبلَ التاريخِ حيواناتٍ بِدِقَّةٍ تُذهِلُ. هذه الرسومُ لم تكنْ زينةً، بل طقوسًا سحريَّةً لصيدٍ ناجحٍ. وفي العصرِ الإسلاميِّ، تحوَّلتِ الزخرفةُ إلى لغةٍ روحانيةٍ، فالنقوشُ الهندسيةُ في مسجدِ قرطبةَ لم تكنْ فَنًّا للعَيْنِ فحسب، بل صلاةً بِلا كلماتٍ.
الفنُّ كصوتِ المُضطَهَدِينَ
وفي القرنِ العشرينَ، حوَّلَ بيكاسو لوحتَه “غرنيكا” إلى صرخةٍ ضدَّ وحشيةِ الحربِ. تلكَ اللوحةُ التي رسمَها بِألوانٍ قاتمةٍ بعدَ قصفِ القريةِ الإسبانيةِ، أصبحتْ أيقونةً للسلامِ. هكذا، يصيرُ الفنُّ سلاحًا في يدِ الضعفاءِ.
الفصل الرابع: أنواعُ الفنِّ.. ألوانٌ لا تُعدُّ
الفنونُ التشكيليةُ: حوارٌ بينَ اليدِ والعقلِ
مِنْ ريشةِ ليوناردو دا فينشي في “الموناليزا” إلى منحوتاتِ رودانَ التي تَشْهَقُ بالحياةِ، الفنونُ التشكيليةُ تُجسِّدُ الأفكارَ في مادةٍ. حتى العمارةُ، كالكاتدرائياتِ القوطيةِ التي تلامسُ السحابَ، هي شعرٌ مُنْثورٌ بالحجرِ.
الفنونُ الأدائيةُ: رقصُ الأجسادِ معَ الألحانِ
ماذا لو غنَّى الجسمُ؟ في المسرحِ الإغريقيِّ، كانَ الممثلونَ يرقصونَ على قصصَ الآلهةِ. وفي باليه “بحيرةِ البجعِ” لتشايكوفسكي، تحوَّلتِ الحركةُ إلى موسيقى صامتةٍ. حتى أنَّ الفيلسوفَ نيتشه قال: “بدونَ موسيقى، تكونُ الحياةُ غلطةً”.
الفصل الخامس: تاريخُ الفنِّ.. مِنْ الأهراماتِ إلى بيكاسو
عندَ الفراعنةِ: فنٌّ للخلودِ
بنى المصريونَ الأهراماتِ كسلالمَ إلى السماءِ، ونحتَوا تماثيلَ تُجسِّدُ الملوكَ بِوجوهٍ لا تعرفُ الزمنَ. حتى أنَّ كتابَ “الموتى” كانَ لوحةً فنيةً تروي رحلةَ الروحِ.
عصرُ النهضةِ: ولادةُ الإنسانِ مِنْ جديدٍ
عندما رسمَ مايكل أنجلو “آدمَ” على سقفِ كنيسةِ سيستينا، جسَّدَ لحظةَ لقاءِ الإلهِ بالإنسانِ. هنا، لم يعُدِ الفنُّ دينيًّا فحسب، بل إنسانيًّا بِامتيازٍ.
الفصل السادس: الفنُّ والجمالُ.. هل هما توأمانِ؟
حينَ يثورُ الفنُّ على الجمالِ
ظنَّ الناسُ لقرونٍ أنَّ الفنَّ يجبُ أن يكونَ جميلًا، حتى جاءتْ حركةُ الدادائيةِ في القرنِ العشرينَ، فعرَّتِ الفنَّ مِنْ كلِّ زينةٍ. قدمَ مارسيل دوشامب “نافورةَ” المرحاضِ كعملٍ فنيٍّ، قائلاً: “الجمالُ ميتٌ، عاشِ العبثُ!”. لكنَّ هذه الثورةَ نفسَها كانتْ جماليةً في فوضاها.
الخاتمة: الفنُّ.. نبضُ الإنسانيةِ الأزليُّ
في النهايةِ، يبقى الفنُّ هو ذلكَ السرُّ الذي يجعلُنا نبكي أمامَ لوحةٍ، أو نرتعدُ عندَ سماعِ مقطوعةٍ. إنه ليسَ ترفًا، بل ضرورةٌ كالهواءِ. فكما قالَ تولستوي: “الفنُّ نارٌ تُشعِلُها الأرواحُ العظيمةُ، ومَنْ يقتربُ منها يَشتعلُ”. فهل نجرؤُ على الاقترابِ؟